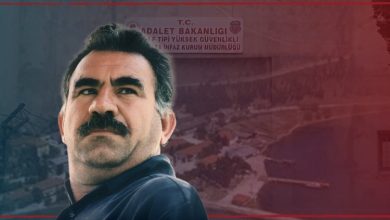الإبادةُ الثقافيةُ شكلٌ من التطهيرِ العِرقيِّ أكثر مخاضاً نسبةً إلى الإبادةِ الجسدية
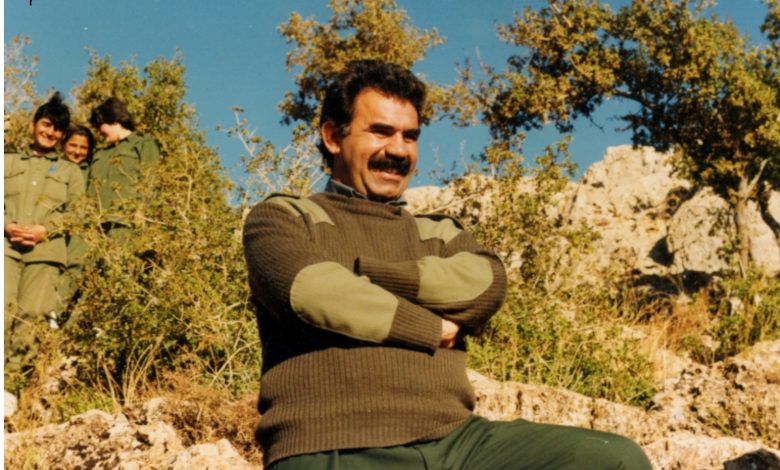
الإبادة: تَهدفُ الإبادةُ، التي هي بمثابةِ امتدادٍ لظاهرةِ الصهر، إلى التصفيةِ التامةِ فيزيائياً وثقافياً للشعوبِ والأقلياتِ وجميعِ أنواعِ الجماعاتِ والمجموعاتِ الدينيةِ والمذهبيةِ والأثنيةِ التي صَعُبَ تذليلُها بأسلوبِ الصهر. حيث يُفَضَّلُ أحدُ هذَين الأسلوبَين حسبما يتوافقُ معه الوضع. حيث يُطَبَّقُ أسلوبُ الإبادةِ الجسديةِ عموماً على المجموعاتِ الثقافيةِ التي هي في منزلةٍ أعلى حسب ثقافةِ النخبةِ الحاكمة، أي حسبَ ثقافةِ الدولةِ القومية. والمثالُ النموذجيُّ على ذلك هو الإباداتُ الجماعيةُ وعملياتُ الجينوسيد المُطَبَّقةُ على الثقافةِ والشعبِ اليهوديّ. فنظراً لكونِ اليهودِ يشكِّلون على مدى التاريخِ الشرائحَ الأمنعَ والأقوى في ميدانِ الثقافتَين الماديةِ والمعنويةِ على السواء، فقد تعرَّضوا دوماً لضرباتِ وإباداتِ الثقافاتِ المهيمنةِ المضادة، وطالَتهم مِراراً عملياتُ التطهيرِ المسماةُ بالمذابحِ المنظَّمة. أما اختباراتُ الإبادةِ الثقافيةِ التي هي ثاني أسلوبٍ في الإبادة، فغالباً ما تُطَبَّقُ على الشعوبِ والجماعاتِ الأثنيةِ
والمجموعاتِ العقائديةِ التي هي في وضعٍ واهنٍ ومتخلفٍ نسبةً إلى ثقافةِ الدولةِ القوميةِ والنخبةِ الحاكمة. وبالإبادةِ الثقافيةِ كآليةٍ أساسية، يُرامُ إلى تحقيقِ التصفيةِ التامةِ لتلك الشعوبِ والمجموعاتِ الأثنيةِ والدينيةِ ضمن بوتقةِ ثقافةِ ولغةِ النخبةِ الحاكمةِ والدولةِ القومية، ويُسعى إلى القضاءِ على وجودِها بإقحامِها في مِكبَسِ كافةِ أنواعِ المؤسساتِ الاجتماعية، وعلى رأسِها المؤسساتُ التعليمية. الإبادةُ الثقافيةُ شكلٌ من التطهيرِ العِرقيِّ أكثر مخاضاً نسبةً إلى الإبادةِ الجسدية، وتمتدُّ على سياقٍ طويلِ الأَمَد. والنتائجُ التي تُفرِزُها أفظَعُ مما عليه الإبادةُ الجسدية، وتُكافِئُ أكبرَ أنواعِ الفواجعِ مما قد يَشهدُه شعبٌ –أو جماعةٌ ما–في الحياة. ذلك أنّ الإرغامَ على التخلي عن وجودِه وهويتِه وعن جميعِ المُقَوِّماتِ الثقافيةِ الماديةِ والمعنويةِ الكائنةِ في طبيعةِ مجتمعِه، إنما يُعادِلُ الصَّلبَ الجماهيريَّ الممتدَّ على مرحلةٍ طويلةِ المدى. يستحيلُ الحديثُ هنا عن العيشِ في سبيلِ القيمِ الثقافيةِ المُعَرَّضةِ للإبادة، بل لا يُمكنُ الحديثُ سوى عن التأوُّهِ والأنين. فالألمُ الأصليُّ الذي تتسببُ به الحداثةُ الرأسماليةُ لكلِّ الشعوبِ والطبقاتِ المسحوقةِ والمتروكةِ عاطلةً عن العملِ بُغيةَ تحقيقِها ربحَها الأعظميّ، لا ينبعُ من استغلالها إياها مادياً وحسب؛ بل هو ألمٌ يُجتَرُّ بسببِ صَلبِ جميعِ قِيَمِها الثقافيةِ الأخرى. ذلك أنّ الاحتضارَ على الصليبِ هو الحقيقةُ التي تَشهدُها كافةُ القيمِ الثقافيةِ الماديةِ والمعنويةِ الخارجةِ عن الثقافةِ الرسميةِ للدولةِ القومية. وبالأصل، يستحيلُ تحويلُ البشريةِ والبيئةِ الأيكولوجيةِ إلى مصدرٍ للاستهلاك، ويستحيلُ تعريضُها للنَّفاذ فيما خَلا ذلك من أساليب.
الثقافة: بِوِسعِنا صياغةُ تعريفٍ عامٍّللثقافةِ على أنها تكامُلُ كافةِكينوناتِ المعاني والبُنى التي كَوَّنَها المجتمعُ البشريُّ على مدارِ السياقِ التاريخيّ. وبينما تُعَرَّفُ كينوناتُ البنى على أنها تكامُلُ المؤسساتِ المنفتحةِ للتحول، فمن الممكنِ تعريفُ كينوناتِ المعاني على أنها مستوى أومضمونُ المعاني المتنوعةِ والغنيةِ والمترابطةِ ببعضها البعضِ تبادُلياً وبالتكافُؤِ ضمن تلك المؤسساتِ المتحولة. وإذ ما عَزَّزنا التعريفَ بتشبيه، فبالإمكانِ تحديدُ كينونةِ البنيةِ بوصفِها الإطارَ الماديَّ الملموسَ للبنية، وتحديدُ المعنى بوصفِه مضمونَ هذا الإطارِ الماديِّ الملموس، أو بكونِه قانونَه الذي يُحَرِّكُه ويُصَيِّرُه مشحوناً بالعواطفِ والمشاعرِ والأفكار. بمُستطاعِنا القولُ أننا نَدنو هنا من مصطلَحَي “الطبيعة” و”الروح Tin” لدى هيغل. كما وبالمستطاعِ أيضاً القولُ على وجهِ الخصوصِ أنّ المعنى الذي أضفاه هيغل على هذَين المصطلحَين ومضمونَ التعريفِ الذي صاغَه لهما قبل مائتَي عام، قد تَعزَّزَ وترسَّخَ أكثر مع المستجداتِ العلميةِ اللاحقة.
التعريفُ الضيقُ للثقافةِ كثيرُ التداولِ إلى حدٍّ ما. يُعمَلُ هنا بالأغلب على تحديدِ الثقافةِ بأنها المعنى والمضمونُ وقانونُ البنيةِ وحيويتُها. وعندما يَكُونُ المجتمعُ موضوعَ الحديث، فإننا نُعَرِّفُ الثقافةَ بالمعنى الضيقِ بأنها عالَم المعنى لدى المجتمع، وقانونُ أخلاقِه، وذهنيتُه وفنُّه وعِلمُه. وبتوحيدِ المؤسساتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ مع هذا المعنى الضيق، يجري العبورُ إلى التعريفِ العامِّ للثقافةِ بالمعنى الواسع. بالتالي، لا يُمكنُ الحديثُ عن المجتمعِ بِحَدِّ ذاتِه باعتبارِه وجوداً، إلا بوجودِ أرضيةٍ مؤسساتيةٍ ومعنىً جوهريٍّ له. بينما الحديثُ عن المجتمعِ المؤسساتيِّ الخالصِ أو مجتمعِ المعنى الخالص، أمرٌ مُضَلِّلٌ وخادعٌ إلى درجةٍ كبيرة. ذلك أنّ مجتمعاً منفرداً بذاتِه لن يستطيعَ التحولَ إلى هويةٍ أو إطلاقَ تسميةٍ على ذاتِه من حيث كونِه وجوداً وكياناً، إلا إذا كان يَتمتعُ بمستوى كافٍ من المعنى والمؤسساتية. أما الحديثُ عن المجتمعِ المؤسساتيِّ المحضِ أو مجتمعِ المعنى المحض، وافتراضُ إمكانيةِ العيشِ بإنسانيةٍ في هكذا مجتمعات؛ فيُحكَمُ عليه بكونِه خطأً وانحرافاً وتدنياً أخلاقياً وشناعة، مثلما ذُكِرَ ونُوِّهَ إليه في المجتمعاتِ على مدى التاريخ.
محالٌ الحديثُ عن معنى مجتمعٍ ما أو عن ثقافتِه الضيقة، بَعدَ بَعثرتِه مؤسساتياً. بهذا المعنى، فالمؤسسةُ كالكأسِ المليئةِ بالماء. ساطعٌ جلياً أنه لا يُمكنُ الحديثُ عن وجودِ الماءِ بَعدَ تَحَطُّمِ الكأس. وحتى لو أَمكَن، فهو لَم يَعُدْ ماءً بالنسبةِ لِمالِكِ الكأس، بل هو عنصرُ حياةٍ متدفقةٍ في أراضي أو أوعيةِ أناسٍ آخرين. في حين أنّ النتائجَ المتمخضةَ من خُسرانِ المعنى والذهنيةِ والجماليةِ الاجتماعيةِ أفجعُ وأفظعُ من ذلك بكثير. ففي هكذا حالةٍ لا يُمكنُ الحديثُ سوى عن تألُّمِ واصطفاقِ كيانٍ أَقرَبُ إلى الكائنِ الحيِّ المقطوعِ الرأس. بمعنى آخر، فمجتمعٌ خاسرٌ لعالَمِه الذهنيِّ والجماليّ، أَشبَهُ بِجِيفةٍ متروكةٍ للتفسخِ والتمزُّقِ والانقضاضِ عليها بوحشية. بناءً عليه، ولتعريفِ مجتمعٍ ما ثقافياً، يُشتَرَطُ حتمياً تقييمُه ضمن تكامُلٍ كلياتيٍّ على صعيدِ المؤسساتيةِ والمعنى. وأبسَطُ مثالٍ بمقدورِنا تقديمُه في هذا المضمار، هو واقعُ المجتمعِ الكرديِّ الذي نَشهَدُ مأساتَه الدراميةَ بكثافة. فنظراً لمعاناتِه من التمزُّقِ العميقِ والخُسرانِ الذهنيِّ مؤسساتياً ومعنىً على حدٍّ سواء، فلا يُمكننا تسميةُ المجتمعِ الكرديِّ إلا بـ”مجتمعِ الإبادةِ الثقافية”.
اللغة: يرتبطُ مصطلحُ اللغةِ بمصطلحِ الثقافةِ بأواصر متينة، مُشَكِّلاً أساساً العنصرَ الرئيسيَّ في حقلِ الثقافةِ بمعناه الضيق. لذا، بالإمكانِ تعريفُ اللغةِ بمعناها الضيقِ على أنها الثقافةُ أيضاً. فاللغةُ بذاتِها تعني الزخمَ الاجتماعيَّ للذهنيةِ والأخلاقِ والجمالياتِ والمشاعرِ والأفكارِ التي اكتسَبَها مجتمعٌ ما. وهي الوجودُ الهوياتيُّ واللحظيُّ المُدرَكُ والمُعَبَّرُ عنه بالنسبةِ للمعنى والعاطفة. والمجتمعُ المُعَبِّرُ عن ذاتِه يدلُّ على امتلاكِه الحجةَ القويةَ للحياة. ذلك أنّ مستوى رُقِيِّ اللغةِ هو مستوى تقدُّمِ الحياة. أي أنّه بقدرِ ما يَرقى مجتمعٌ ما بلغتِه الأمّ، يَكُونُ قد ارتَفعَ بمستوى الحياةِ أيضاً بالمِثل. وبقدرِ ما يتعرضُ مجتمعٌ ما لخُسرانِ لغتِه ولحاكميةِ ونفوذِ لغاتٍ أخرى، يَكُونُ مُستَعمَراً ومتعرضاً للصهرِ والإبادةِ بالمِثل. واضحٌ بسطوعٍ أنّ المجتمعاتِ التي تحيا هذا الواقعَ لن تتمتعَ بحياةٍ مفعمةٍ بالمعاني ذهنياً وأخلاقياً وجمالياً، بل سيُحكَمُ عليها بحياةٍ مأساويةٍ إلى أن تُمحى وتَفنى بوصفِها مجتمعاتٍ مَريضة. هذا ولا مَهربَ من توظيفِ القيمِ المؤسساتيةِ للمجتمعاتِ التي تعاني من فُقدانِ المعنى والجمالياتِ والأخلاقِ كمادةٍ خامّةٍ لقِيمِ المستعمِرين. خلاصةً؛ إذا تمَّ عيشُ لغةٍ كما هي الحالُ لدى الكردِ مثلاً، فجليٌّ جلاءَ النهارِ أنّ مجتمعاً يمرُّ بحالةٍ كهذه سوف يَغدو مقهوراً وبائساً ماديّاً حتى الحضيض، وسيَسقطُ في وضعِ التشتُّتِ إرباً إرباً؛ ولن يتخلصَ بالتالي من العيشِ مشحوناً بالأخطاءِ والخياناتِ والشناعاتِ معنىً وأخلاقياً وجمالياً.
عبد الله أوجالان
هذه المقالة مأخوذة من العدد الأول لمجلة نيسان، أغسطس-سبتمبر